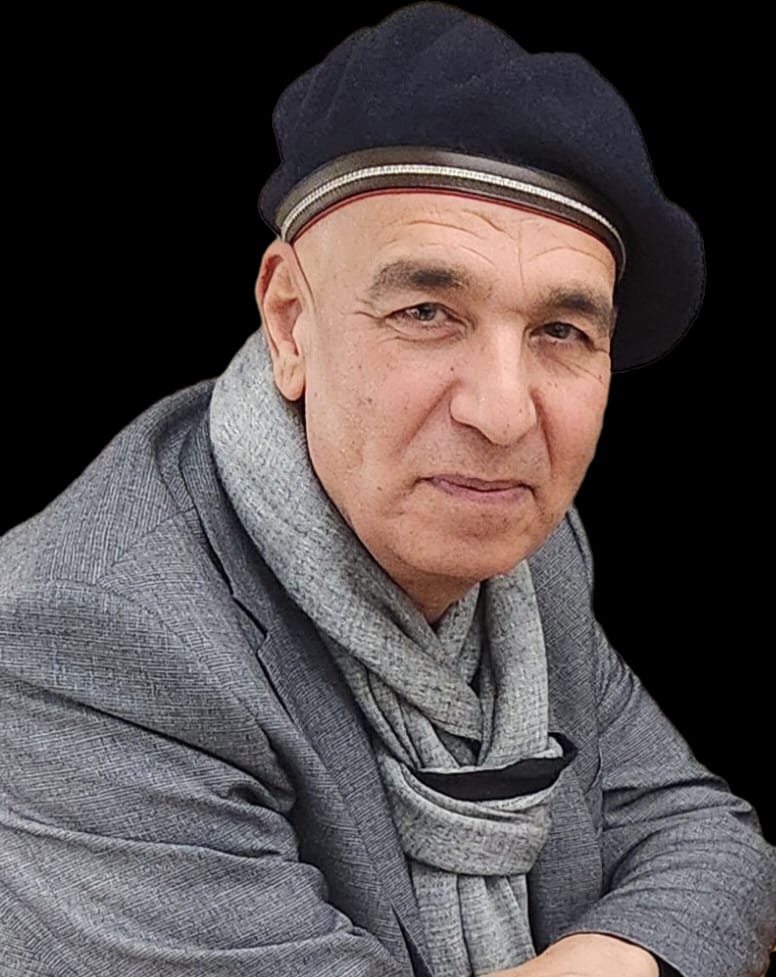
كتب رياض الفرطوسي
لم تكن الحرب على غزة مجرد حملة عسكرية ضد أرض محاصرة، بل كانت إعلاناً مفتوحاً عن دخول المنطقة مرحلة جديدة من الجنون الاستراتيجي، حيث لا حدود للدم، ولا أفق للعقل، ولا وزن للسياسة. فمنذ أن اندلعت شرارة العدوان، ظن العالم أنه يتعامل مع "حدث أمني"، لكنه سرعان ما وجد نفسه أمام نار تستعر من البحر إلى الصحراء، ومن رفح إلى طهران.
اقتربت الحرب من إتمام عامها الثاني، ولم تحصد فيها إسرائيل غير الرماد. غزة المدمرة تنهض من بين أنقاضها بشعب لا يموت، والمقاومة، وإن خُنقت بالجغرافيا، اتسعت في الوجدان العربي والإسلامي والعالمي. أما إسرائيل، فقد فقدت بوصلتها بين أنفاق القطاع وصواريخ الشمال، ثم ارتبكت أكثر عندما قررت فجأة أن توسّع مسرح النار ليطال طهران. هناك، لم يكن الردّ خطاباً، بل صواريخ دقيقة وأهداف منتقاة، وهزيمة نفسية لم تشهدها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منذ قيام الدولة عام 1948.
الضربة الإيرانية على الداخل الإسرائيلي لم تكن مجرد ردّ تقني على عدوان. كانت صفعة مزلزلة لمنظومة بأكملها، من سلاح الجو الذي لطالما تباهى بتفوقه، إلى أجهزة الاستخبارات التي فشلت في التنبؤ، إلى القيادة السياسية التي باتت تُدار من داخل الملاجئ. نتنياهو نفسه يعيش محاصراً بالخوف، والسفير الأمريكي يتنقل بين الملاجئ أكثر مما يتنقل بين العواصم.
وهنا يبدو المشهد أكثر جلاءً إذا ما قورن بتجارب أخرى. فحين ضُرب حزب الله في لبنان، انهارت الدولة، وارتبك الحزب، وغرقت المقاومة في الحسابات الإقليمية. سوريا، حين داهمتها الحرب، سقطت في الفوضى، وتحوّل النزيف إلى انتحار طويل الأمد. أما في إيران، فقد استُهدفت المنشآت، واستُشهد القادة، لكن البنية لم تهتز، والقرار لم يتصدّع. لماذا؟ لأن المعركة لم تكن قراراً طارئاً، بل عقيدة طويلة النفس.
في هذه اللحظة، لا يمكن تجاهل بنية الخوف التي صمّمتها إسرائيل عبر عقود، تلك التي نسميها بـ"هندسة الخوف"؛ حيث لا تُبنى السياسات على قوة واقعية، بل على صورة مُضخّمة تُبث في العقول: جيش لا يُقهر، استخبارات لا تخطئ، ردع فوري وساحق. كانت إسرائيل تدير المنطقة من خلال هذه المعادلة الذهنية لا من خلال الحقائق. لكن صواريخ إيران على العمق الإسرائيلي مزّقت تلك الهندسة من أساسها، وأسقطت القبة النفسية قبل القبة الحديدية. لقد بدا واضحاً أن ما كان يُخيف الآخرين لم يكن سوى وهم كبير تم ترميمه بالدعاية والسرديات، لا بالفعل والصلابة.
في هذه اللحظة العاصفة، علينا أن نستعيد درس 1967. حينها، ضُربت المطارات العربية في اللحظة الأولى، فسقط الطيران، وسكتت العواصم. اعترف عبد الناصر بنفسه أن العرب هزموا قبل أن تبدأ الحرب. لم تكن الهزيمة في السماء، بل في العقل. في غياب التخطيط، في الانجرار وراء الواجهة دون تحصين العمق. أما إسرائيل اليوم، فهي تحارب طهران لا وحدها، بل ومعها واشنطن، وباريس، وبرلين، وكل من يخشى ولادة شرق أوسط لا يُدار من تل أبيب. ومع ذلك، تواجه إيران وحدها، وتردّ وحدها، وتقف وحدها. وهذا لا يعني انتصاراً نهائياً، لكنه يكشف هشاشة الطرف الآخر.
تظن تل أبيب أنها بتوسيع رقعة النار ستعيد فرض شروطها في المفاوضات النووية، أو تقدم "هدية دموية" لحليفتها الأمريكية. لكنها في الحقيقة، تفقد تماسكها الداخلي، وتضعف قدرتها على المناورة. فليس من مصلحة أحد أن تتحول الضربات التكتيكية إلى دوامة إقليمية. ما يحدث اليوم ليس مجرّد تصعيد، بل انهيار تدريجي في مفاهيم الأمن، وخسارة صامتة لمصداقية إسرائيل أمام العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة نفسها.
إن إسرائيل، بعد أن أحرقت غزة، تريد الآن أن تجرّ المنطقة كلها إلى قاع اللهب. لكنها تغفل أن النار، حين تمتد بهذا الشكل الأحمق، لا تفرّق بين من بدأها ومن سيُحرق بها. لا يمكن لإسرائيل أن تكسب حرباً ضد من لا يهاب الموت، ولا تستطيع أن تروّض شعباً اكتشف أن الحصار أهون من الذل، وأن الهدم أرحم من الانكسار.
لقد آن للعقلاء في هذا العالم أن يتدخلوا، لا لأنهم يؤمنون بالعدالة، بل لأنهم باتوا يرون أن إسرائيل لم تعد قادرة على الانتصار، ولا راغبة في السلام، وأن استمرار الحرب لن يُنتج سوى دمار شامل. يجب على واشنطن، وباريس، وموسكو، وبكين، والعواصم العربية أن تُجمِع على أمر واحد: كفى عبثاً. لا إيران يمكن أن تُلغى، ولا إسرائيل يمكن أن تبقى دون عقل.
نحن في لحظة مفصلية. إما أن ندرك أن الإدارة الرشيدة للأزمات تصنع التوازن في قلب الحرب، وإما أن نترك المنطقة تتحول إلى رماد دائم. إسرائيل، في وهمها القديم، كانت تعتقد أن تفوقها العسكري سيكفي لإخضاع الشرق الأوسط. لكن الصدمة الكبرى أنها وجدت نفسها في مواجهة منظومة جديدة، لا تشبه الجيوش العربية التي انهارت في ستة أيام، ولا القيادات التي كانت تسلم مفاتيح العواصم قبل أن تبدأ المعارك.
الآن، السؤال الذي يجب أن يُطرح: هل ستتعلم إسرائيل من هذا الانهيار الاستراتيجي؟ أم ستظل تمارس سياسات الانتحار البطيء؟ الإجابة، كما يبدو، تكتب اليوم من داخل الملاجئ. والملاجئ لا تُنتج قادة، بل تُخرج المهزومين.