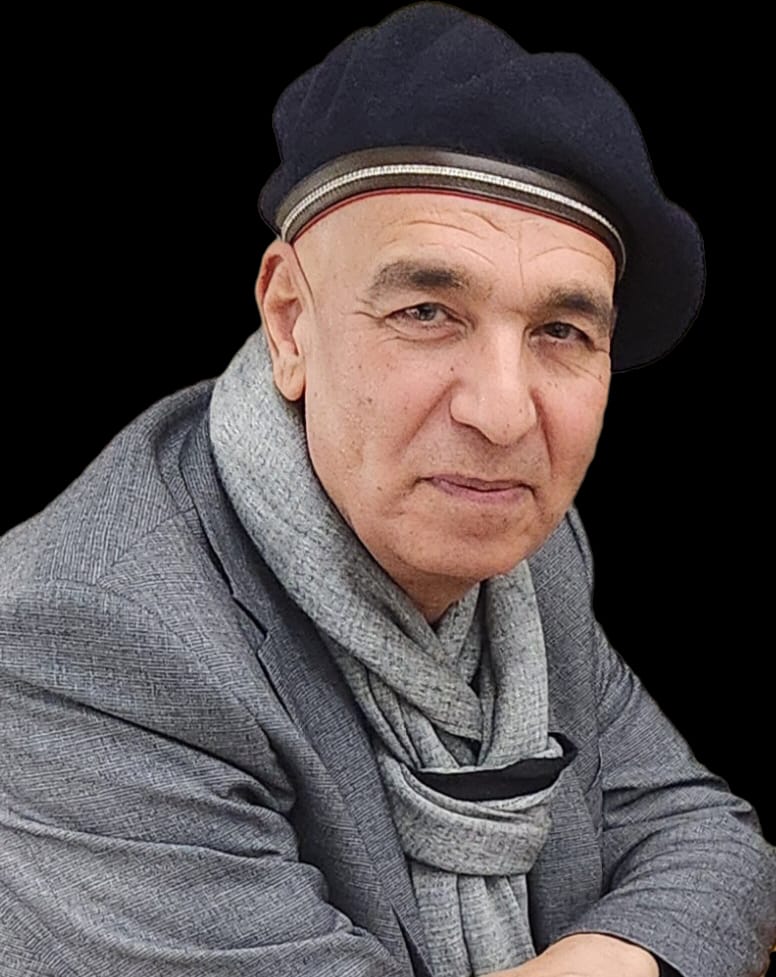
كتب رياض الفرطوسي
في مدنٍ خجولة الضوء، حيث الزمن لا يمشي بل يتكئ على حافة الذكرى، كان المنفيون العراقيون يعيشون في مكان ويحدقون في مكان آخر. لاجئون؟ ربما في الأوراق. سياسيون؟ على الأغلب في النوايا. لكن الحقيقة أنهم كانوا يعيشون في كبسولة ذهنية محكمة الإغلاق، حيث لا يدخل ضوء ولا يخرج سؤال.
ذهبوا إلى العالم ولم يعبروا حدوده. مرّوا ببراغ ولندن وطهران ودمشق وستوكهولم وامستردام ، لكن المدن مرّت عليهم كما تمرّ الأغاني القديمة على أذن متعبة. لم يتعلموا من الغربة سوى تفاصيل الترقب، لم يقرأوا من منافيهم غير وجوه بعضهم، ولم يكتبوا من قصتهم سوى الفصل الأول: كيف خرجنا.
كأنهم صعدوا قطاراً متجمّداً، لا يتحرك إلا داخلياً، يطوف على محطات فكرية منتهية الصلاحية، يجترّ مفاهيم قديمة عن السلطة والمظلومية والنقاء الثوري. الذين قضوا سنين في باريس لم يعرفوا ما تعنيه الحرية في فرنسا، والذين أمضوا عقدا في لندن لم يتعلموا ما هي الدولة الحديثة. تقوقعت عقولهم في شعارات الماضي، كما تتقوقع يرقات الحشرات في شرنقتها، لا تنتظر الفجر بل تستنسخ الليل.
كانوا يظنون أن المنافي تُربّي وعياً، لكنها في حالتهم، لم تُنضج سوى الحنين. والحنين، حين يتحوّل إلى مشروع سياسي، يكون أسوأ من الطغيان: يجمّل الماضي، يحرّف المستقبل، ويُسوّق الأكاذيب بلهجة الضحية. ولأنهم عاشوا سنين في الظلال، صدّقوا أن الظلال هي الحقيقة.
حين سقط الطاغية، لم ينهضوا بل عادوا يجرّون وراءهم خرائط مشروخة. كانت بغداد تنادي بأصوات جديدة، وهم يجيبون بألسنة قديمة. وكأن المنافي لم تمرّ بهم أصلًا. وكأنهم حين غادروا، أوقفوا الزمن في دواخلهم ثم أعادوه كما هو، مثل شريط تسجيل لم تُمسّه يد التعديل. تكلّس الوعي، وتخشبت اللغة، وصار الوطن مجرّد قاعة انتظار لأوهامهم الحزبية.
عادوا بخطاب لم يختبر الواقع، وبنظارات لا ترى سوى الأعداء، وبقلوب هجرتها القدرة على التأمل. حملوا معهم "قضيتهم" كما تُحمل الحقائب، ممتلئةً بالكتب الصفراء، والبيانات التي لا تقرأ الحياة، والذاكرة التي لا تنسى شيئاً ولا تتعلم شيئاً. لم يسألوا أنفسهم: هل نحن حقاً نعرف العراق؟ أم نعرف فقط العراق الذي كان في كتيّبات التنظيم؟
وأسوأ ما في الكبسولة الذهنية أنها لا تحميك من العالم فقط، بل تحجب عنك نفسك. فصار بعضهم نسخة قديمة من نفسه، يلوك الجمل ذاتها، يشير إلى الخيانة ذاتها، ويتبنى النقاء ذاته، لكن بلباس دولة وبسلطة حزب وبكرسي مكتب فخم. أما الغربة التي عاشها، فلم تكن إلا ديكوراً لسيرة ذاتية.
في مقاهي المنافي، كانت الحكايات تبدأ من لحظة الهروب ولا تنتهي. شاعر صامت يشرب شايه البارد ويتذكّر زنزانته. مفكر حزبي يبحث في الأرشيف عن جملة لم تكتمل. إسلامي قديم يصارع شكوكه على عتبة الإيمان. كردي شاب يسأل: "هل الوطن خريطة أم ذاكرة؟". وامرأة تكتب رسائلها إلى وطن لا يجيب.
كانوا يكتبون كثيراً، يقرأون كثيراً، لكن لا أحد قرأهم. لا أحد صدّق أنهم جادّون في بناء وطن. لأن الوطن ليس فكرة محفوظة، بل علاقة حية. وليس شعاراً، بل مسؤولية. ولأنهم فشلوا في اختبار العلاقة، استبدلوه بعقيدة. ومن العقيدة صنعوا السلطة، ومن السلطة صنعوا خيبةً جديدة.
وحين عادوا، عادوا كما خرجوا: بذات الهواجس، بذات التحفظ، بذات اللغة المؤجلة. حتى الكراهية التي كانت تستهدف الطاغية، انتقلت بمرونة إلى "الآخر" الجديد، وكل "آخر" هو مشروع تهديد محتمل. كأنهم لم يغادروا لحظة الصراع الأصلية، بل أخذوها معهم في حقائبهم، وأعادوا بثها بعد سنوات، بلغة أشد تعقيداً.
إن سؤال "ماذا فعل بنا المنفى؟" لم يُطرح كفاية، وربما لأن الجواب مخيف. المنفى لم يكن عن الأرض فقط، بل عن النفس، عن الجماعة، عن اللغة. عن احتمال أن تكون مخطئاً. عن شجاعة المراجعة. لكنهم لم يراجعوا شيئاً، لأن من تربّى على الشعارات لا يحتمل المرآة.
وهكذا بقيت الكبسولة الذهنية مغلقة بإحكام. تسافر، لكنها لا تتحرك. تتحدث، لكنها لا تصغي. تسرد، لكنها لا تتذكر. تتقدم، لكنها تعود من حيث بدأت: خوفاً من السؤال، وهروباً من الحقيقة، وإيماناً مَرَضياً بأن الماضي وحده هو البرهان.
وهذا هو الدرس القاسي للمنفى: أن تعيش الغياب طويلًا لا يعني أنك فهمت معنى الحضور.